| ¨° الإسلامي °¨ جميع ما يتعلق بالشريعة علماً و فكراً و منهجاً . قضايا معاصرة - أحكام - فتاوى - نصائح - بحوث شرعية - مقالات |
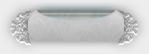 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ¨° الإسلامي °¨ جميع ما يتعلق بالشريعة علماً و فكراً و منهجاً . قضايا معاصرة - أحكام - فتاوى - نصائح - بحوث شرعية - مقالات |
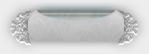 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موضوع متجدد وسأنقل لكم كل مرة إن شاء الله حديث إخترته للنبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن ينفعنا جميعا به الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. هذا الحديث من أشهر الأحاديث، وقد اتفق العلماء على صحته وقبوله، وأفرده بعضهم بمصنفات مستقلة لعظيم شأنه وجليل خطره، بل عده بعضهم ثلث الإسلام، وعده بعضهم ربع الإسلام، بل قد قال ابن مهدي -رحمه الله تعالى- في فضل أو في شأن هذا الحديث: "أرى أن كل من صنف مصنفًا أن يبدأ بحديث النيات" يعني بذلك هذا الحديث، وأهل العلم قد سلكوا هذا المسلك، فصدر كثير منهم مصنفه بهذا الحديث، وعلى رأس أولئك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه. ولهذا الحديث من باب الفائدة قصة يحسن أن تذكر ليعلم خبرها. ذكر بعض أهل العلم أن رجلًا يكنى أو رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة بقصد أن يتزوج امرأة تكنى بأم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولأجله جاء هذا الحديث، والصحيح والتحقيق أنه لا علاقة لهذا الرجل بهذا الحديث، وعلى قول من قال بأن ذلك الرجل هو سبب الحديث فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما، "إنما" هنا أداة حصر، وفي اللغة أساليب للحصر ومن أشهرها "إنما" أي إنما كل عمل بنية، لا عمل إلا بنية، ولهذا لا يتصور أن يعمل إنسان عملًا بلا نية، بخلاف المجنون، وبخلاف النائم، وبخلاف الصغير الذي لا يفقه، هؤلاء يتصرفون تصرفات لا تحكمهم نية، ولا مقصد لهم. إنما الأعمال بالنيات، اعتبار النية في جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه كمال عدل الله جل وعلا، فيه كمال عدل الله، لكل امرئ ما نوى يعطي الله من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدًا، ولهذا من ما جاء في القرآن الكريم من الضوابط الكبيرة أن الجزاء من جنس العمل: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا . إذًا فمن كمال عدل الله أن من أحسن فله ومن أساء فعليه؛ ولذا كان من تعبيرات أهل السنة، يعطي الله من يشاء بفضله، ويعاقب ويحرم ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدًا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فيه الترغيب في الإخلاص، وفيه أن من أراد الإخلاص أُعِينَ عليه ودُلَّ عليه وهدي إليه، فمن أخلص في نيته لله -جل وعلا- وعلم الله صدق نيته وطيب طويته، أعانه على بلوغ مقصوده وآجره على عمله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيه الترهيب من الرياء، وأن من أراد بعمله الرياء فقد وكَلَه الله إلى نيته، وقد وكله الله -تعالى- إلى مراده، وفيه أيضًا موافقة السنة للقرآن الكريم. من المعلوم أن للسنة مع القرآن وظائف، تارة تكون السنة مؤكدة، لما جاء في القرآن كهذا الحديث: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من هاجر بقصد الخير، فله، ومن هاجر بقصد غير الخير فعليه، ولا يظلم ربك أحدًا، وفيه أن قبول العمل لا بد له من أمرين أو من متلازمين الصلاح أو الإخلاص في الباطن، والاتباع في الظاهر، الإخلاص في نيته، والاتباع في عمله، وإذا افترق أحد الأمرين عن الآخر حصل الخلل في العمل، فكم من عامل على غير إخلاص، وكم من مخلص على غير عمل؛ ولهذا لا بد من اجتماع هذين الأمرين الإخلاص والاتباع، وهنا مسألتان: الأولى: النية عند الفقهاء أو عند العلماء لها اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار المقصود، من العمل هل هو لله أو لغير الله، والاعتبار الثاني باعتبار تمييز العمل، تارة يكون العمل فرضًا، وتارة يكون نفلًا، وتارة تكون عبادة مالية، وتارة تكون عبادة قولية وهلم جرا، لكن يجمع هذا الأمر أن العمل لا بد أن يكون العامل فيه مخلصًا لله. المسألة الثانية: إذا خالط العمل شيء يشوب الإخلاص، قال العلماء أو قال أهل العلم: ذلك على أحوال، إذا كان قصد العامل من أصل عمله الرياء فعمله حابط لا إشكال في ذلك، القصد الثاني: إذا عمل العمل لله، ثم صاحبه نية أخرى، مثال ذلك، رجل ذهب ليعلم العلم ويبصر الجهلاء احتسابًا، ثم داخله الرغبة في أخذ المال على هذا العلم، العلم لله -جل وعلا- وإنما أخذ المال أو داخلته هذه النية بعد نيته الأصلية، قالوا: لا يأثم، ولكن يقل أجره عما كان عليه. الأمر الثالث: إذا عمل العمل لله، ثم صاحبه أو جاء الرياء قيل: إن دافعه ونازع نفسه في رده فهو مأجور وليس بمأزور، وإذا استرسل معه، وترك الزمام لنفسه فقد أثم باختياره، ويتحمل تبعته. الحال الرابع أو القسم الآخر: لو عمل عملًا فأثني عليه ومدح عليه وكان ذلك بغير اختياره هل يأثم؟ لا يأثم؛ لأن ذلك من عاجل بشرى المؤمن إلا إذا زينت له نفسه ذاك ونسي فضل الله عليه، ولهذا قد يعمل العامل العمل ويكون وحيدًا لا يراه أحد، لا يطلع عليه زيد ثم يشيع خبره فيتناقل الناس خبره فيحمد ويمدح، ولكن لا يؤثر فيه مدح الناس ولا ثناء الناس، بل يزداد أو يزيده ذلك المدح إخلاصًا لله ولا يؤثر فيه في أن يشوبه عجب أو حب لثناء الناس أو مدحهم. ولهذا من لطائف كلام أهل العلم أن إخلاص العامل كلما قوي كلما كان عمله أفضل، قال ابن القيم أو غيره: ربما يعمل العبد العمل في جوف الليل، لا يراه أحد فيكون حظه الوزر، وربما يعمل العمل ويكون عمله في حماليق أعين الناس يرقبونه من كل جهة، فيكون مخلصًا في عمله ذاك، والضابط هنا سلامة الباطن، قد يعمل الإنسان العمل، يقوم الليل لكن تعجبه نفسه أنا أحسن من فلان، ينتظر من الله جزاء وشكورًا كأنه يمن على الله -جل وعلا- تعجبه نفسه، ينسى بعض تقصيره لإعجابه بقيامه، فهذا آثم، لكن من عمل العمل والجموع تنظر إليه، وكانت نيته لله ومقصده لله وجاهد نفسه في أن يقيم العمل في الباطن والظاهر على الوجه الذي يرضي الله، فهو من خير وعلى خير وإلى خير. المسألة الأخيرة: الهجرة، الهجرة أنواع تارة تكون الهجرة واجبة إذا كان في أرض سوء، في أرض كفر، لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضًا مما تكون الهجرة فيه واجبة إذا علم المرء من نفسه أنه قادر على نشر خير وإزالة منكر لا يزول إلا به، وأمر بالمعروف لا يكون إلا بحضوره، وبالمثال يتضح المقال، فلان من الناس له قدرة علمية، أو قدرة سلطانية، يعلم أنه بذهابه إلى بلد ما فيه الشر والشرك أنه بذهابه سيزول ذلك الأمر وينقلب العسر يسرًا، والشر خيرًا، فهنا يجب أن يذهب لأنه قادر ولا يكون هذا إلا بحضوره بعلمه أو بسلطانه.
وأيضًا مما ذكر أهل العلم في الهجرة من هاجر لطلب علم، كمن يسافر، قالوا: هذا يؤجر عليه، ومن ذلك الرحلة في طلب العلم أو في طلب علاج لا يكون في بلد المسلمين، أو يكون في بلد المسلمين ولكن يعجزون عنه وسيترتب على بقائه مضرة، وهناك أقسام تدخل تبعًا في تلك الأقسام. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#2 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث الثاني إن المقسطين عند الله على منابر من نور وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " أخرجه مسلم. إن المقسطين كلمتان مترادفتان قريبتان في الرسم واللفظ، المقسطون والقاسطون، المقسطون محمودون، والقاسطون غير محمودين، المقسطون العادلون: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ والقاسطون الجائرون الظالمون: " وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا." وقوله : على منابر، فيه أن العدل رفعة في الدنيا بمرضاة الله تعالى، ورفعة في الآخرة بإكرام الله لأولئك المقسطين، برقيهم ورفعتهم على تلك المنابر، وقوله من نور فيه أن العدل نور في الدنيا وقرة عين لمن عدل، وجزاء ذلك نور في الآخرة، كما أن الظلم ظلم في الدنيا أو ظلام في الدنيا وظلام في الآخرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي قوله : على يمين الرحمن زيادة في إكرامهم؛ فجهة اليمين جهة تشريف وتكريم، وكلتا يديه يمين، جاء في بعض الروايات : بيده الشمال، بعضهم ضعفها سندًا، وبعضهم قال على صحتها، فهذا الحديث كلتا يديه يمين في البركة والخير حتى لا يتوهم أن الشمال أضعف من اليمين، كما هو في غالب حق الآدميين، وفيه إثبات صفة اليدين لله تعالى. والقاعدة العقدية عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى لها أمور ثلاثة :
إثباتها من الكتاب والسنة، والثاني: تنزيهها عن صفات النقص والعيب، والثالث: الإيمان بأنها حقيقة، وعدم تأويلها أو تكييفها أو تشبيهها، والقاعدة الأخرى: أن القول في صفة من صفات الله، كالقول في سائر الصفات، فهذه القاعدة، أي: الإيمان بصفات الله -جل وعلا- من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حقيقة قاعدة مطردة في جميع الصفات، قد نص على ذلك أهل العلم، كشيخ الإسلام في التدمرية في قواعده المشهورة. الذين يعدلون في حكمهم، فيه شمولية العدل في كل شيء: في القول، في الفعل، في النفع القاصر على نفسه، والنفع المتعدي لغيره: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا إذا كنت مأمورًا بالعدل مع أهلك ومع نفسك فمع الناس من باب أولى؛ ولذا من كمال الإسلام في مسألة العدل أن العدل في كل شيء حتى في الجوارح، ولهذا من لطائف ما يذكر، ما ذكره بعض شراح الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة ذكروا عللًا أنها مشية الشيطان، وذكروا من ذلك أن هذا فيه جور مع القدم الأخرى، وهذا القول لطيف يحكى في مسألة العدل. لكن الشأن أن العدل في كل شيء : "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" ويزداد الأجر عظمًا، في العدل مع من خالفك وظلمك، قد يخالفك مخالف فلا تكون المخالفة سبيلًا إلى ظلمه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". العدل ثقيل على النفوس، وبخاصة مع المخالفين، لكن الإنصاف أن يجعل المسلم نصب عينيه : " وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا " أو كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: قل الحق ولو قال به عدو بعيد، وقل بأن هذا باطل ولو قال به صديق قريب، أيضًا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما وَلُو، أي: ما تولوا من ولايات، وما قاموا عليه من مسئوليات، نص أو خص هذا؛ لأن عدم العدل هنا يكون فيه الضرر متعديا، وأنت تعلم أن ظلم الاثنين أشد من ظلم الواحد، وأن ظلم العشرة أشد من ظلم الخمسة، ولهذا كان الوعيد للقاضي شديدا إن ظلم، كما أن الوعيد للحاكم السلطان شديد إن ظلم لعظم الضرر المترتب على ظلمهما سواء من القاضي أو من السلطان. كما جاء المدح لمن قضى ولمن حكم بالعدل وبخاصة في حق من يلي أمور الناس من القضاة والسلاطين. وفيه أيضًا أن العدل متلازم مع الأمانة، العدل لا يكون أو لا يتصور إلا مع الأمانة فيما قضى؛ ولهذا قال بعض العلماء عند قوله تعالى:" إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " هذه الآية جعلت العمال على أربعة أقسام، قسمة عقلية لا بد منها: إما أن يكون أمينًا بلا قوة، أو أن يكون قويا بلا أمانة، أو أن يكون لا أمانة ولا قوة، أو أن يكون أمينًا قويا، والعدل أو العادل لا بد فيه من شرطي الأمانة والقوة، بل لا يتصور أن يكون عدلا منفذا إلا بالقوة والأمانة، وفي ذلك أن على دعاة الخير وطلبة العلم أن يحكموا العدل على أنفسهم، قد تحمل على أحد العصاة المسلمين أمرًا في نفسك لخبر شاع عنه أو لمعصية تلبس بها وجهر بها، لكن هذا لا يمنع من العدل معه، وأن يقال أصاب في إصابته وأخطأ إذا أخطأ، أما أن يُستصحَب الحال في بغضه، فيُظلَم، ويجعل الأصل في كلامه الظلم، ويُنحَى عنه العدل فهذا من الجور؛ ولهذا جاء في بعض الروايات أن يهوديا اشتكى عليا إلى شريح، فدخل علي وخصمه عند شريح، فأجلس شريحٌ عليا مع خصمه، وكلكم يعلمها، فعجب اليهودي من هذا فقال: دين يأمر بهذا لا خير فيمن تركه، فأسلم. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#3 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث الثالث يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أخرجه الترمذي، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله: قد أذهب عنكم فيه أن دين الإسلام دين كمال، شامل لكل الخيرات منقىً من جميع السلبيات، دين شمل جميع المصالح الذي يكون بها قوام الدين والدنيا والآخرة. وقوله: عِبِّيَّة أو عُبِّيَّة الجاهلية يعني الكبر والتفاخر، قال بعضهم: مأخوذ من عباب الماء إذا ارتفع، والمتكبر يرتفع على الآخرين. وقوله: وتعاظمها بآبائها فيه ذم التعاظم بالأنساب على سبيل انتقاص الآخرين وازدرائهم، وأن من اتصف بذلك بتعصبه بالنسب أنه متشبه بالجاهليين في تعصبهم وتفاخرهم بآبائهم، وهنا يحسن أن يقال: إن تفاضل الناس فيما بينهم في الغالب لا يخرج عن أربعة أمور: بالنسب ،وبالحسب، وبكثرة المال، أو كثرة الولد، في الغالب أن هذه الموازين يفخر بعض الناس على بعض أو يتفاخر الناس بها، ولكن هذه الموازين لاغية لا تنفع أصحابها إلا إذا كانت في طاعة الله : فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ هذا ميزان النسب، وميزان الحسب والفخر بالعشيرة : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ فإن كان حسبه منصبه أو سلطانه، فقارون وفرعون لم ينفعهما جاههما ولا حسبهما. وأما ميزان كثرة المال والولد : يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ بقي ميزان واحد جاء مفصلًا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، فإذا رأيت الإنسان يفتخر بنسبه أو بعنصره، أو بقوميته الإقليمية أو القبلية، ويزدري الآخرين فاعلم أنه متشبه بصفات الجاهليين؛ فالجاهليون كانوا يتفاخرون ويتعاظمون، وانظر إلى أبي جهل لما صعد ابن مسعود على ظهره أو على بطنه احتقره قبحه الله، ولمزه برويع الغنم من الأنفة التي كان يعتز بها، ولكن لم ينفعه ذاك : فقـد رفـع الإسلام سلمان فارسا ... وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب وقوله : بر تقي وفاجر شقي هين على الله، أيضًا يفيد أن التقوى هي الميزان وهي الرفعة الحقيقية، وقوله والناس بنو آدم، هذا فيه رد على النظرية الإلحادية التي تزعم أن أصل الإنسان كان حيوانًا، وهي نظرية كما قيل: بطلانها يغني عن إبطالها، ونكارتها تغني عن إنكارها، وسقوطها يغني عن إسقاطها، نظرية النشوء والارتقاء والتطور، بأن أصل الإنسان كان قردًا، ثم مع تقادم الزمن تكوَّن حتى أصبح بهذه الصورة، فهذه نظرية كفرية إلحادية. وقوله: والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب فيه أن أولى الناس بالبعد عن ذلك هم أهل العلم ودعاة الخير؛ لأنهم أعلم الناس بأسباب التقوى، وأسباب التواضع، وأن يكونوا أبعد الناس عن التفاخر بأنسابهم وأحسابهم، ومن أسباب تفرق المسلمين التعصب للقومية، فهناك قومية عربية بحكم الانتماء للعنصر العربي، وهناك قومية إقليمية، أو قطرية أو قَبَلية، وكل هذه القوميات كلها من طبائع الجاهليين؛ لأن الإسلام نبذها وجعل الرابطة الشمولية : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ . وفي استدلاله أو في ذكره -صلى الله عليه وسلم- لهذه الآية مسألة يحسن أن تذكر، وهي ما يسمى بتضمين الكلام للآيات، يقول بعض أهل العلم : لا يجوز أن تضمن الآيات في كلام الناس ألبتة، بمعنى: لو كنت تتكلم في كلام ثم دخل شخص أو تكلم شخص مثلًا اسمه يوسف، فتقول يوسف أعرض عن هذا، أو رجل اسمه موسى في يده شيء تقول وما تلك بيمينك يا موسى يمنع من هذا منعًا باتًا، وبعض أهل العلم يقسم المسألة إلى أقسام ثلاثة فيقول: إذا كان تضمين القرآن للكلام الماجن فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه استخفاف واستهزاء بالقرآن الكريم، وقد ذكر بعض الأدباء في كتبهم أمثلة أُجِلُّ لساني وأسماعكم عنها. والقسم الثاني : أن تذكر الآية في الكلام الجادّ وليس بالهزل من باب التأكيد، وهذا يجوز كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في كثير من الأحاديث ومنها : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ومنها : لما أتى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت علي وفاطمة -رضي الله تعالى عنهما- فقال : قوما فصليا، فقال علي -رضي الله تعالى عنه - إن شاء الذي خلقنا بعثنا، فخرج عليه الصلاة والسلام، وهو يضرب فخذه بيده ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا . وقد ذكر ابن حجر وغيره، أن فيه جواز انتزاع الشاهد أو الاستشهاد بالآية في الكلام، قسم آخر وهو تضمين القرآن في الشعر، طبعًا إن كان الشعر ماجنًا فيلحق بالقسم الأول؛ لأن النبي -عليه السلام- يقول : الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح أما إذا كان الشعر جادًّا ومعانيه صحيحة، قالوا فيترخص في هذا، ومثلوا بقول الشاعر: يا من عدا ثم اعتـدى ثم اقـترف ... ثم انتهـى ثم ارعـوى ثم اعترف أبشـر بقـول اللـه في آياتــه ... إن ينتهـوا يغفر لهم ما قـد سلف وقول الآخر لما أقرض صاحبه دينًا، قال : أنلني، يعني : أعطني من النيل : أنلـني بالـذي استقـرضت خطـا ... وأشـهد معـشرًا قـد شاهــدوه فـإن اللــه خــلاق البرايــا ... عنـت لعظمـة هيبتـه الوجــوه يقــول إذا تــداينتم بـديــن ... إلـى أجــل مســمى فاكتبـوه وبكل حال من منع استشهاد الآيات في الشعر قال من باب قوله تعالى : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ عودًا على الحديث فيه على دعاة الخير أن يكونوا أبعد الناس من هذه الخصال الجاهلية،
التعصب والتفاخر وأن ذلك يدل على ضعف في الإيمان، وعلى عدم عدل مع الإخوان، فأولى الناس بالتواضع والبعد عن التفاخر هم دعاة الخير، |
|||||||||
|
|

|
|
|
#4 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث الرابع ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم عن مالك بن الحويرث -رضي الله تعالى عنه- أنه قال:
" أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " أخرجه البخاري. وأخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال: هو أول حديث في فضل طلاب الحديث، قوله: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وبخاصة من قدم من خارج البلد،طلبًا للعلم، وفيه الحرص على طلب العلو؛ لأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لأن مالكا وأصحابه كانوا شبيبة فرحلوا لطلب لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- والسماع منه، ففيه فضل الرحلة للتلقي من كبار أهل العلم، ويستحسن بعض أهل العلم أن لا يرحل الطالب عن بلده حتى يأخذ عن أشياخ بلده، وقوله: ونحن شببة متقاربون فيه حرص صغار الصحابة وشبابهم على طلب العلم، ناهيك عن كبارهم، بل قد قال بعض أهل العلم: وكثير من الصحابة طلبوا العلم وهم كبار وبخاصة من أسلم كبيرًا، لم يمنعه السن والشيب عن طلب العلم؛ ولهذا بعض الناس يتذرع ويتعذر بعدم طلب العلم باشتعال شيب رأسه، وهذا قد حرم نفسه، فقد يُحصِّل في أيام يسيرة مع صدق النية وقوة العزيمة، ما يضعف عنه من يقوم في سنين عددًا، وإذا بارك الله فلا منتهى لبركته عز وجل. وقوله: فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة فيه أن العلم يحتاج إلى مثابرة وإلى مجاهدة للنفس، قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد من مجاهدة ومن تركِ الترفه والتنعم الزائد، كان أهل العلم يرحلون الأزمنة الطويلة في طلب إسناد حديث واحد أو في لقي رجل واحد، وكلكم يعلم رحلة شعبة بن الحجاج -رحمه الله- التي طوَّف فيها شهرًا كاملًا لتتبع إسناد حديث كان يرجو صحته، وكذا رحلة أبي حاتم الرازي، وأبي نصر المروزي وغيرهم، ومن قرأ كتاب رحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، رأى نماذج عليا ومُثلًا تحتذى في قوة العزيمة والمثابرة. وقوله أيضًا: فأقمنا عنده فيه أصل سكن طلبة العلم بجوار الشيخ، يعني سكن الطلاب بجوار الشيخ سنة ماضية، فمالك وأصحابه -رضي الله تعالى عنهم- أقاموا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من باب تسهيل الأخذ عنه. قوله: وكان رحيمًا رفيقًا، فيه عظيم خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- ومحبته لطلبة العلم: " بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ " يؤخذ من ذلك رحمة المعلم بتلاميذه، والترفق بمن تعلمه أيا كان، يستفاد أن تعليم العلم للناس وبخاصة من جاءك راغبًا مبتدئًا أن تترفق معه، وأن تتحبب إليه، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فلما رأى أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا فيه عظيم فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة فراسته، وفيه أيضًا أنَّ على المعلم أن يحرص على تفقد طلابه، وأن يلاحظ مشاعرهم، أن يرقب مشاعرهم، فبذا وذاك تعرف ما يدور بإذن الله في نفوس طلابك، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهم بوادر أو قرائن تدل على شوقهم واشتياقهم واشتهائهم للعودة إلى أهليهم، فقال ارجعوا، حقق ما في أنفسهم، قد يستحي الطالب منك، قد يكون محتاجًا، فيمنعه حياؤه وهيبتك من سؤلك المال، قد يكون مشتاقًا للرجوع لكن يمنعه الحياء، وكلما كان المعلم على حرص، وعلى تفقد، وعلى سؤال قد يوكل المعلم أحد الطلاب لتفقد مشاعر الطلاب لحاجياتهم، يمنعه الحياء، الحياء قد يمنع أحيانًا من سؤال المعلم، ألم يقل علي - رضي الله تعالى عنه - كنت رجلًا مذاء فاستحييت من سؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله، فالطالب قد يستحي من معلمه، وعلى المعلم أن يعنى بهذا الأمر بالتفقد والسؤال، والبحث من طرف خفي، قد يسد خلة محتاج أو يحقق رغبة محتاج بأمر يسير. وقوله: سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فيه أن عناية المعلم لا تكن بالطالب فحسب، بل بأهله بالسؤال عن والديه، بالسؤال عن حاله عن أولاده إن كان له أولاد، بالسؤال عن أموره، فهذا يحبب الطالب إلى المعلم، ومن باب أولى لازم ذلك أن يحب الطالب العلم، فإذا علم الطالب أن المعلم يعنى به ويهتم ويسأل عنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، زاد حب الطالب وتعلقه بمعلمه، أما إذا كان المعلم لا يسأل ولا يهتم ولا ينظر، فإن ذلك قد يكون سببًا رئيسًا في نفور الطلاب أو في عدم تحصيلهم أو في عدم أخذهم من معلمهم. وقوله: ارجعوا إلى أهليكم فيه حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على إعطاء كل ذي حق حقه، ولهذا بعض من يطلب العلم يهمل أمر والديه، وأمر زوجته وأولاده، ويظن أنه بهجرته وبتركه لهم في أجر، هذا من الجهل، فصّل أهل العلم في ذلك، سأل أحدهم الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله الرجل يرحل لطلب العلم ويمنعه والداه ما يصنع؟ قال: أما ما لا بد له منه فليرحل، وما سوى ذلك فالوالدان، فليلزم الوالدين، بعض الناس يترك أولاده أضاع أولاده وأهله وجاء لطلب العلم، العلم يمنعك من هذا، العلم يأبى عليك هذا، ولهذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك الشاب الذي أراد الجهاد، جهاد تحت راية شرعية في وقت النبوة، ومع ذلك كله رده النبي عليه الصلاة والسلام، ألك والدان؟ قال: نعم، لعلمه بحاجتهما له، ففيهما فجاهد. وقوله: فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فيه أن على طالب العلم أن يزكي علمه بتعليم نفسه أولًا، وبتعليم من يعول من زوجة أو أولاد أو خدم أو ما شاكل ذلك؛ لأن بعض الناس كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، لا ينفع نفسه ولا ينفع أهل بيته، ولا أقاربه، إنما علمه لغير أهل بيته، والأولى بك أن تبدأ بنفسك وتعلم من تعول. وقوله: وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها من أمانة الصحابي في النقل أنه ذكر أشياء ونسي أشياء، وفيه أيضًا تواضع الصحابي، لو لم يقل لا أحفظها لم يعلم أحد لكن من أمانته في النقل أنه اعترف بأنه حفظ أشياء وغابت عنه أشياء، ومن لازم الخصال المحمودة، بل الواجبة في طالب العلم أن يكون أمينًا فيقول ما له به علم ويتورع، بل يكف عما ليس له به علم. وقوله: وصلوا كما رأيتموني أصلي فيه تعليم العلم بالقول والعمل، المعلم قدوة في قوله وعمله، علمهم أشياء بقوله، وأمرهم أن يتعلموا من فعله صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا كان بعض الصحابة يتقدم يصلي بهم، ويقول: والله ما تقدمت لأني الأحق ولكن لأريكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقدوة الفعلية أبلغ، فطالب العلم كالغيث، مبارك أينما كان، في جميع شئونه، بأقواله وأفعاله ولباسه وصمته، وكلامه، ولهذا بعضهم يستفيد من الشيخ إذا كان الشيخ يتمثل السنة في أخلاقه في صلاته في لباسه، رأى ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- الربيع بن خثيم ، فقال لو رأى هذا نبي الله -عليه السلام- لأحبه، لسمته وخلقه وطيب شمائله. وقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه عظيم نفع العلم مع صاحبه، فيه عظيم نفع العلم لصاحبه في سفره وحضره، طالب العلم معه الزاد في كل مكان في السفر والحضر، في الحل والترحال، في الليل والنهار، العلم نور، أما الجاهل فيتعسر ويقع ويسقط، أما طالب العلم فعلمه نور في كل مكان، |
|||||||||
|
|

|
|
|
#5 | ||||||||
|
عضو نشيط
|
رد: في رحآب الحديث
جزأكم الله خيراً |
||||||||
|
|

|
|
|
#6 | ||||||||
|
عضو متميز
|
رد: في رحآب الحديث
جزاك الله خير |
||||||||
|
|

|
|
|
#7 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
|
|||||||||
|
|

|
|
|
#8 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث الخامس جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قوله : يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص شباب الصحابة على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبة العلم أولى الناس بالبحث والتحري لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- علمًا وعملًا. وقوله : كأنهم تقالُّوها فيه أن العبرة بالكيف لا بالكم ليست العبرة بكثرة العبادة والتلاوة، إذا لم تكن مأطورة بإطار المنهج الشرعي، فالخوارج لم تنفعهم عبادتهم : تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذون والنتيجة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي سورة الغاشية: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ خشوع وعمل ونصب والنتيجة تصلى نارًا حامية، إذًا فالعبرة ليست بالكثرة إن لم تكن الكثرة منضبطة بأصل الشرع إنما العبرة بالكيف. وقوله : قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا إلى آخره، إلى آخر أقوال الثلاثة، فيه أن الاستحسان العقلي للعمل لا يصيره مشروعًا، الاستحسان العقلي لا يصير العمل مشروعًا، لا بد من العلم، العقل قد يستحسن أشياء قد يصيب وقد يخطأ لكن الحكم هو ماذا؟ هو العلم، وهذه أبياتًا لطيفة في تحاور العلم والعمل، دليل أن العلم هو الأكمل وأن العقل تابع والعلم متبوع، يقول الشاعر: علـم العليم وعقل العاقل اجتمعـا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفـا فالعلم قـال أنـا أحـرزت غايتـه والعقـل قـال أنا الرحمن بي عرفـا فـأفصح العلم إفصاحًـا وقـال له بأينـا الرحـمن فـي قرآنـه اتصفا فبـان للعقـل أن العلــم سـيده فقبـل العقـل رأس العلـم وانصرفا العلم متبوع فاستحسان الشخص بعقله لعمل من الأعمال لا يصيره مشروعًا، بل يكون العامل مأزورًا إذا لم يتثبت من المنهج الشرعي في هذا العمل، ولم تفتح أبواب البدع إلا بالاستحسان العقلي وترك النص الشرعي؛ ولهذا فضلت ليالٍ، وفضلت أيام وليالٍ، وفضلت أماكن بمجرد الاستحسان العقلي، فأصبحت أبوابًا من أبواب البدع : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ لكنهم ردوه إلى عقولهم وشهواتهم. قوله : أنتم الذين قلتم كذا وكذا فيه أن المنهج التثبت من القول قبل عتاب قائله، وفيه أيضًا التثبت من قبول الشائعات، وبناء الأحكام عليها دون النظر في حقيقتها، بعض الناس إذا جاءه الخبر بنا عليه الأحكام من اتهام أو تبرئة أو جرح أو تعديل، ولو بحث في حقيقة الأمر لوجد أنه ظلم من عدل وعدل مع من ظلم، ولهذا النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا قال لهم؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قد يكون متأكدًا من هذا قد يكون الناقل ثقة، لكن من باب المنهجية. ولما قالت الأنصار أو قال بعض الأنصار : أعطى المهاجرين وتركنا، أمر بهم فقال لهم : يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، استفهم مع أنه على علم ويقين أنهم قالوا، لكن من باب التثبت في الخبر وحتى يعلموا قولهم، أو يعلموا خطأهم بتقريرهم عليه، فما القول في بعض دعاة الخير، من يبني بغضه لشخص لمجرد خبر وصل إلى سمعه، وقد يكون الخبر مكذوبًا، وقد يكون الخبر مبالغًا فيه، وقد يكون الخبر من شامت أراد الشماتة بأخيه، فكان الأولى بك، أن تنهج هذا النهج ما مقالة بلغتني عنكم أنتم الذين قلتم كذا وكذا : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ . قوله : أما والله إني لأخشاكم لله، فيه جواز تزكية المرء لنفسه للمصلحة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أتقى الخلق لله، وأكرم الخلق على الله، وقد ذكر العلماء في مباحث تزكية النفس أنها مكروهة في حق الناس : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ . وفي الحديث الصحيح : لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم إلا إذا كان في التزكية مصلحة، كما قال يوسف عليه السلام : اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ أخيرًا في قوله : فمن رغب عن سنتي فليس مني،
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هم أتوا طمعًا في التزود من الخير، لكن لأنهم خالفوا المنهج النبوي، وأرادوا أن يكونوا كما أملت عليهم رغباتهم. بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن هذا من الخطورة بمكان، فمن رغب عن سنتي -لو تكفلوا للتعبد إذا كان على خلاف السنة- فليس مني. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#9 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث السادس يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه. قوله: يا معشر الشباب فيه عناية الإسلام بهذه المرحلة؛ ذلك لأن الشباب أو مرحلة الشباب هي أخصب مراحل العمر، فيها يبني المرء شخصيته، ويشق طريقه؛ ولذا كثرت النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المرحلة العمرية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : سبعة يظلهم الله في ظله فقال : أو شاب نشأ في طاعة الله وكذا حديث: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرًا وكذلك حديث مالك بن الحويرث الذي قد سبق : قدمنا ونحن شببة متقاربون وكيف حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم واعتنى بهم وراعى مشاعرهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعدَّ منها "وعن شبابه فيما أبلاه". وفي الحديث المبادرة بالزواج لتحصين الفروج، ويتأكد هذا لمن خشي على نفسه الفتنة وكان قادرًا على الباءة، القوة الجسدية والمالية، وفيه أيضًا بيان خطأ من زعم أن ترك الزواج أفضل من الزواج؛ لأن ترك الزواج يشغل، فلقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ما يحث على الزواج، وكان أكثر هذه الأمة نساءً هو صلى الله عليه وسلم، بحكم ما خصه الله -جل وعلا- به، وحث على الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم . وأما ما يحتج بهم بعضهم من كون بعض العلماء لم يتزوجوا فيحمل على أمور: إما لعدم قدرتهم، أو لعدم تفرغهم، أو لرأي رأوه، لكنه خلاف الرأي الصحيح، وفي الحديث أيضًا العناية بشأن الجوارح، أغض للبصر، وأحصن للفرج، العناية بشأن الجوارح، ولهذا جاءت النصوص الكريمة في القرآن الكريم بالعناية بالجوارح : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ اللسان، السمع : وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ البصر : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . وقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، دليل أن الإنسان قد يرغب بالزواج لكن لا يستطيعه، يعجز، متطلبات الزواج الحياتية قد يعجز عنها، فجعل لك الشرع مخرجًا آخر، فعليه بالصوم فإنه له وجاء : حصانة، فإنه له وجاء، وكثير من الناس يستعيض بالصوم إذا عجز عن الزواج فتكسر شهوته، تكسر شهوته فيدرأ عنه شر كثير، وبعض الناس يفتح لنفسه بابًا من الحرام، فقد يكون قويا في شهوته ويكون عاجزًا عن الزواج، ومع هذا يلجأ إلى طرق محرمة، كالاستمناء أو كإشباع النظر في الصور، وهذا حرام لا يجوز؛ ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وبالآية في المعارج وفي المؤمنون : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ على تحريم الاستمناء. احـفظ منيك ما استطعت فإنـه مـاء الحياة يصب في الأرحـام وطلبة العلم أولى الناس بالزواج، لأن الزواج يهيئ لهم راحة نفسية وبدنية فيستطيعون أن يتعلموا وأن يعلموا،
فإذا قصرت بهم النفقة فيلجئوا إلى الوسيلة الشرعية الأخرى وهي الصوم، وفيه أيضًا البعد عن كل ما يثير الشهوة، وبخاصة إذا علم الإنسان من نفسه الضعف، وبخاصة في هذا الزمن كثرت فيه إثارة الشهوات المسموعة والمقروءة والمرئية، وعودا على بدء طلبة العلم أولى الناس بهذا الأمر يعني بالزواج، وقد ذكر غير واحد من المختصين في الدراسات الاجتماعية، أن الإنسان المتزوج المستقر في حياته ينتج أكثر، وهذا يؤكده ما جاء في النصوص الشرعية من الحث على الزواج؛ لأن الله ركب في بني آدم شهوات، وجعل لهذه الشهوات أماكن، وجبلة الإنسان على هذه الشهوة، يؤجر إن وضعها في حلال، ويؤزر إن وضعها في حرام. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#10 | ||||||||
|
عضو نشيط
|
رد: في رحآب الحديث
جزآك الله كل خير |
||||||||
|
|

|
|
|
#11 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
|
|||||||||
|
|

|
|
|
#12 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث السابع قال سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله  في الحديث القدسي: في الحديث القدسي:( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا )[رواه مسلم]. وعن جابر  أن رسول الله أن رسول الله  قال: قال:( أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم )[رواه مسلم]. والظلم: هو وضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة. وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: ظلم الإنسان لربه، وذلك بكفره بالله تعالى، قال تعالى:  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  [البقرة:254]. [البقرة:254]. ويكون بالشرك في عبادته وذلك بصرف بعض عبادته لغيره سبحانه وتعالى، قال عز وجل:  إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  [لقمان:13]. [لقمان:13]. النوع الثاني: ظلم الإنسان نفسه، وذلك باتباع الشهوات وإهمال الواجبات، وتلويث نفسه بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات، من معاصي لله ورسوله. قال جل شأنه:  وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  [النحل:33]. [النحل:33]. النوع الثالث: ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، والظلم يقع غالباً بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. صور من ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته: غصب الأرض: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال: قال: ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين )[متفق عليه]. مماطلة من له عليه حق: عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله قال: قال رسول الله  : ( مطل الغني ظلم )[متفق عليه]. : ( مطل الغني ظلم )[متفق عليه].منع أجر الأجير: عن أبي هريرة  عن النبي عن النبي  قال: قال: ( قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة...،...، ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره )[رواه البخاري]. وأذكر هنا قصة ذكرها أحد المشايخ في كلمة له في أحد المساجد بمكة، قال: ( كان رجل يعمل عند كفيله فلم يعطه راتب الشهر الأول والثاني والثالث، وهو يتردد إليه ويلح وأنه في حاجة إلى النقود، وله والدان وزوجة وأبناء في بلده وأنهم في حاجة ماسة، فلم يستجب له وكأن في أذنيه وقر، والعياذ بالله. فقال له المظلوم: حسبي الله؛ بيني وبينك، والله سأدعو عليك، فقال له: أذهب وأدعو علي عند الكعبة (انظر هذه الجرأة) وشتمه وطرده. وفعلا استجاب لرغبته ودعا عليه عند الكعبة بتحري أوقات الإجابة، على حسب طلبه، ويريد الله عز وجل أن تكون تلك الأيام من أيام رمضان المبارك  وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ  [الشعراء:227]، [الشعراء:227]، ومرت الأيام، فإذا بالكفيل مرض مرضاً شديداً لا يستطيع تحريك جسده وانصب عليه الألم صباً حتى تنوم في إحدى المستشفيات فترة من الزمن. فعلم المظلوم بما حصل له، وذهب يعاوده مع الناس. فلما رآه قال: أدعوت علي؟ قال له: نعم وفي المكان الذي طلبته مني. فنادى على ابنه وقال: أعطه جميع حقوقه، وطلب منه السماح وأن يدعو له بالشفاء ). الحلف كذباً لإغتصاب حقوق العباد: عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي  أن رسول الله أن رسول الله  قال: قال: ( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة )، فقال رجل: وإن كان شيـئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال: ( وإن قضيباً من أراك )[مسلم]. السحر بجميع أنواعه: وأخص سحر التفريق بين الزوجين، قال تعالى:  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  [البقرة:102]. [البقرة:102]. وعن أبي هريرة  عن النبي عن النبي  قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات )، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات )، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ( ... والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )[رواه البخاري ومسلم]. عدم العدل بين الأبناء: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: ( نحلني أبى نحلاً فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله  ، ، فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: "أكل ولدك نحلت مثله" قال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، وقال: "إني لا أشهد على جور"، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة )[متفق عليه]. حبس الحيوانات والطيور حتى تموت: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: قال:( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها النار) [رواه البخاري ومسلم]. حبستها: أي بدون طعام. شهادة الزور: أي الشهادة بالباطل والكذب والبهتان والافتراء، وانتهاز الفرص للإيقاع بالأبرار والانتقام من الخصوم، فعن انس  قال: ذكر رسول الله قال: ذكر رسول الله  الكبائر فقال: الكبائر فقال:( الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: "شهادة الزور" )[متفق عليه]. وأكل صداق الزوجة بالقوة ظلم.. والسرقة ظلم.. وأذيه المؤمنين والمؤمنات والجيران ظلم... والغش ظلم... وكتمان الشهادة ظلم... والتعريض للآخرين ظلم، وطمس الحقائق ظلم، والغيبة ظلم، ومس الكرامة ظلم، والنميمة ظلم، وخداع الغافل ظلم، ونقض العهود وعدم الوفاء ظلم، والمعاكسات ظلم، والسكوت عن قول الحق ظلم، وعدم رد الظالم عن ظلمه ظلم... إلى غير ذلك من أنواع الظلم الظاهر والخفيى. فيا أيها الظالم لغيره: اعلم أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد مسلماً كان أو كافراً، ففي حديث أنس  قال: قال رسول الله قال: قال رسول الله  : :( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ فإنه ليس دونها حجاب ). فالجزاء يأتي عاجلاً من رب العزة تبارك وتعالى، وقد أجاد من قال: لاتظلمن إذا ما كنت مقتدراً *** فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم فتذكر أيها الظالم: قول الله عز وجل:  وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42)مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء  [ابراهيم:43،42]. [ابراهيم:43،42].وقوله سبحانه:  أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى  [القيامة:36]. [القيامة:36].وقوله تعالى:  سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  [القلم:45،44]. [القلم:45،44].وقوله  : ( إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته )، ثم قرأ: : ( إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته )، ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ  [هود:102]، [هود:102]، وقوله تعالى:  وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ  [الشعراء:227]. [الشعراء:227]. وتذكر أيها الظالم: الموت وسكرته وشدته، والقبر وظلمته وضيقه، والميزان ودقته، والصراط وزلته، والحشر وأحواله، والنشر وأهواله. تذكر إذا نزل بك ملك الموت ليقبض روحك، وإذا أنزلت في القبر مع عملك وحدك، وإذا استدعاك للحساب ربك، وإذا طال يوم القيامة وقوفك. وتذكر أيها الظالم: قول الرسول  : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )[رواه مسلم]. : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )[رواه مسلم]. والاقتصاص يكون يوم القيامة بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات المظلوم، فعن أبي هريرة  عن النبي عن النبي  قال: ( من كانت عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء، قال: ( من كانت عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء، فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )[رواه البخاري]. وعن أبي هريرة  أن رسول الله أن رسول الله  قال: ( أتدرون ما المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: قال: ( أتدرون ما المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار )[رواه مسلم]. ولكن أبشر أيها الظالم: فما دمت في وقت المهلة فباب التوبة مفتوح، قال  : : ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها )[رواه مسلم]. وفي رواية للترمذي وحسنه: ( إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ). ولكن تقبل التوبة بأربعة شروط: 1- الإقلاع عن الذنب.
2- الندم على ما فات. 3- العزم على أن لا يعود. 4- إرجاع الحقوق إلى أهلها من مال أو غيره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#13 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث السابع خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" أخرجه الترمذي. فيه كمال دين الإسلام، وأنه أعطى كل ذي حق حقه،
وفيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ، الذي لم تُغفله أعباء الرسالة وأمور الأمة عن رعاية أهله، بل كما قال هنا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وفيه أن القيام بحق الأهل من التعبد لله تعالى، من التعبد لله تعالى أن تقوم بحق الأهل؛ لأن ذلك أولًا من الواجب الشرعي عليك. وثانيًا : إذا نويت بذلك إسعاد أهلك وإكمال حاجياتهم قربة إلى الله فأنت مأجور، كان بعض السلف يقول، والله إني لأتقرب إلى الله بإخراج القمائم من بيتي، لأن النية تجعل العادة عبادة، ولهذا على دعاة الخير التأدب بهذا. وفيه الرد على من زعم أن دعوة الناس وأن نشره للعلم، أو أن طلبه للعلم يمنعه من القيام بحق أهله، هذا من الجهل، ومن عدم البصيرة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس شغلًا، كان يدعوا الناس، ويستقبل الوفود، ويَسِم إبل الصدقة، ويحضر جنائز المسلمين وقد يشيعها معهم، ويعود المرضى، ويقسم الصدقات بين الناس، وتأخذ الجارية بيده إلى أعالي المدينة، ليقضي حاجتها، ومع هذا كله يقول : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذًا فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، وأما السبب هو الفوضوية في الوقت، والفوضوية في الخروج أو الدخول في المنزل، والفوضوية في عدم ترتيب المشاغل، كم من طالب علم غير متزوج ومخدوم، ولكنه لا يحصل إلا القليل، وكم من طالب علم عنده زوجته وأولاد ومسئولية لكنه يحصل الكثير، وهنا بوادر التوفيق من الله -جل وعلا- تظهر فيمن لزم المسلك الشرعي، وأعطى كل ذي حقه ومستحقَه. وفي الحديث أيضًا أن العناية بشأن الأهل من أسباب التوفيق الإلهي، وهذا مشاهد ومسموع في القيام بحق الأهل كما تقدم آنفًا من الواجبات الشرعية، وإذا قام به العبد تقربًا إلى الله -تعالى- وفيه همة للتزود من العلم أعانه الله -جل وعلا- على جميع شئونه، وعلى جميع حوائجه، أما إهمال البيوت وتضييع الأولاد بدعوى التفرغ، فهذا مأزور وليس بمأجور. |
|||||||||
|
|

|
|
|
#14 | |||||||||
|
عضو مميز
|
رد: في رحآب الحديث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير الجزاء أخي الفاضل وفقك الله لكل خير وجعله في ميزان حسناتك |
|||||||||
|
|

|
|
|
#15 | |||||||||
|
عضو مميز جداً
|
رد: في رحآب الحديث
الحديث الثامن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف" أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، والبيهقي في شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم:
"أكمل المؤمنين إيمانًا" فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أحسنهم خلقًا" فيه عظيم شأن حسن الخلق، ويقابله عظيم قبح سوء الخلق، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم : "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا". جاءت الأحاديث الكثيرة في حسن الخلق والجميع يحفظها، وقد ذكر بعض أهل العلم كلمة جميلة عند قوله جل وعلا : "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" فيه بيان منزلة حسن الخلق لوصف الله -جل وعلا- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- بتلك الصفة، قال بعض أهل العلم : تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم، وفيه أيضًا تفاوت الناس في حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، هناك من يقل، والتفاوت درجات. وقوله : "الموطئون أكنافًا" توطئة لين وتواضع، الذين يألفون ويؤلفون، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف فيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أولى الناس بحسن الخلق، ليألفهم الناس، ولأن من أسباب قبول دعوة الخير محبة الناس لمن دعاهم، وحسن خلق الداعي لهم يهيئهم لقبول دعوته، بل لمحبة دعوته، كما أن سوء الخلق ينفرهم عن دعوته. ومن لطيف ما يذكر ما ساقه الذهبي عن بعضهم قال: إن الرجل السيئ في خلقه إذا دخل منزله توارى عنه أولاده، واختفى أهله حتى إن قطه ينزوي في الجدار من سوء خلقه، فهذا دليل على أن سوء الخلق تتعدى مضرته وأثره، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار بعض الناس قد يكون قليل البضاعة العلمية، لكن بحسن خلقه، وطيب معشره، ولكونه يألف ويؤلف يؤثر في جلسائه، في سامعيه، في رائيه، وبعض الناس قد يكون كثير البضاعة فصيح الكلام بليغ العبارة، لكن لسوء خلقه نفر الناس عنه، وأبغض الناس الحق بسببه، فليكن هذا على داعي الخير أن يضعه نصب عينيه، ولهذا كان من دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الحسن: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وكذا قوله -صلى الله عليه وسلم- وهو أحسن الناس أخلاقًا : اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت . وفي قوله : لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف الحذر من تنفير الناس، ومن الجهالة بمكان أن بعض الناس لا يراعي هذا الأمر، ويقول: لا بد من بيان الحق ولو سخط الساخطون، نعم، هذا لا خلاف فيه، لكن لا يشفع لكلامك هذا أن تسلك تنفير الناس عن قبول دعوتك بخشونة في ألفاظك وسوء أخلاقك، الأسلوب الحسن يجعل البعيد قريبًا بفضل الله، ويجعل العسير يسيرًا بفضل الله، كما أن ضده من سوء الخلق يجعل القريب بعيدًا، كم من سوء خلق بعَّد قريبا، وعسَّر يسيرًا، وكم من حسن خلق قرَّب بعيدًا ويسَّر عسيرًا بفضل الله جل وعلا، فلزوم على من علم من نفسه ومن خلقه أن الناس ينفرون عنه أن يجاهد نفسه، وأن يوطن نفسه، وأن يكثر من الدعاء. ويستحسن هنا ذكر النظرية الباطلة التي يزعم بعض مُنَظِّريها، أن الإنسان لا يستطيع أن يغير أخلاقه بل يكون كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس، بعض الفلاسفة اسبينوزا وغيره ملاحدة زعموا أن الأخلاق لا تقبل التغير، وهذه النظرية باطلة شرعًا وعقلًا، فالكافر يسلم، والمسلم قد يكفر، تغيرت عقائد وأديان ألا تتغير أخلاق؟! ومن أسباب تغيير الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يُعْطَه تفعُّل، بذل الأسباب استفراغ الجهد من يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه، فشاهد القول أن على طلبة العلم وعلى دعاة الخير أن يراعوا هذا الجانب؛ فقد كان نبينا -عليه الصلاة والسلام- أكمل الناس خلقًا، ونحن نرى في مجتمعنا أو نرى فيمن نعاصر ونعاشر من يؤثر على الناس بسمته ووقاره، ولو كان علمه قليلًا، كما أنا نرى أن بعض الناس قد يكون عنده علم يتميز بين أقرانه، لكن سوء الخلق حرمه وحرم غيره من خير كثير. أقف عند هذا الحد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. |
|||||||||
|
|

|
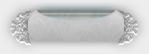 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|